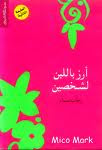عن دمشق.. أو ما بقي منها
خالتي أم سمعان طلبت حضوري..
في الطريق المتعِب من دمشق إلى حمص، والطريق المفرح من حمص إلى الساحل.. لم يغب عن بالي الكتاب الشهير لغاستون باشلار "جماليات المكان" طوال الطريق المؤدي إلى بيتها.. بيت خالتي أم سمعان، راجعت بدقة شروط المسكن المقدس.. حيث امتلك البيت الذي تسكنه "أم الأمهات" كل المفردات المؤسسة للبيت الأول.. امتلك المركز وثبته بالشجرة المباركة، السدرة أجمل الأشجار وأكثرها إثارة لخيالات الروح، الحجر الأزرق الصلد الذي احتجز بصمته المكان، وهيمن على صوت رنين جرس الكبش الأول، يقود قطيعه عائدا من البرية، امتلك منزلها درجاً صاعداً نحو وجه الآلهة الأكثر حنواً، يعلو باطراد حجرا على حجر صعوداً صعودا.. والباحة الدائرية المكشوفة كانت "الفضاء" المكثِف للطاقة الكونية، ظلت منذ استدارتها الكاملة تبعث رسائلها إلى الله الرحيم..
وصلت "باب جنة".. وصلت بيت خالتي أم سمعان.. رصت صفوف الكراسي الملتفة مثل حلزون، اجتمعنا نحن الصبايا حول حدث حمل نكهة عطرة، نكهة الأحمر الكرزي، وطعم حلاوته.. حلاوة الفرح، كنا نحتفل بزواج آخر بنات خالتي أم سمعان.. نورما.. جميلتها التي لم تحبذ ضيق الصفوف الإسمنتية في مدرسة الضيعة، ولم تحد انطلاقتها بكتب المدارس.. فتركت بكل وعي، العلم والجامعات، للفاشلات أمثالنا، القليلات الحظ ، القليلات الجمال.. وانطلقت مثل الغزالة البرية، تقطف العنب، وتشعل الأعراس رقصا وغناء.. إذا كان عرس نورما، صديقتنا، حبيبتنا..
في وسط الباحة، والأوكسجين الباذخ، والغيم القطني غرقنا بالجمال.. ما بين الأهازيج، وصياح الصبايا، وخفة ظلهن، وصوت الضحك الصداح.. زهت بيننا خالتي أم سمعان، اشتعلت عينيها ببريق الفخر، وشفافية الفراق..أعلنت بكبرياء فطرتها، بتجاعيد وجهها الجليلة، ببياض بشرتها الحليبية، وهيبة طلتها، أعلنت أم سمعان خبراً أسعدها حتى هطلت دموعها.. خبرتنا: عريس نورما شامي.. إجا من الشام ليتجوز.. ونورما بنتي رح تعيش معه بالشام.. بالكّباس!!
ثم ختمت الضحكة المحرجة بزغرودة ساندها الكل بزغردتها.. وأنا الوحيدة التي تسكن في الشام غصصتْ !!
نورما في الشام.. نورما في الكبّاس.. هي مجرد حكاية..
حكاية بسيطة،عتيقة.. حكاية الريف والمدن.. حكاية الفلاح وابن المدينة! حكايتنا مع الشام..
لن أعود إلى نورما الآن، فقصتها واضحة.. قصتها قصة النقيض.. الصدمة، والتأقلم.. الوفرة، وعسف الموارد.. المساحة والضيق.. الهواء القابل للتنفس، والسخام الملتصق بالروح.. الحجر والاسمنت المغبر.. العمارة البسيطة المقدسة.. والعمارة الشيطانية لجدران من بلوك وأسقف من ألواح التوتياء، نشأت مثل فطور لا تقهر، تكاثرت اعتباطاً على أرض مهدورة، بلا إنسانية.. بلا خدمات..
حسناً حسناً.. أرى النظرة المستسخفة في عيون قرائي.. أرى السخرية، والهزء من سذاجة الطرح، وبراءة التحليل المقتربة من الغباء.. أرى هزة الرأس المتسامحة في أحسن الأحوال، والفهم العميق لوعي الواعيين.. هي الضريبة أيتها الحاذقة! الضريبة التي علينا أن ندفعها كي نسكن مدننا، ونعيش المدنية! أرى واسمع كل شتيمة يطلقها كل متهم لي بتأليه الريف المغلق، والنزعة الخبيثة لتريف الأماكن، وتخريب المدن المفتوحة، أرى الرعب في نظرة كل من يقرأ عن الجمال المضلل، خائفا على وجه حضارته، من طرح ساذج يعلن ويدافع عن الريف، عبر تكريس تقاليد التريف على أهل المدن، وعراقة المدن، وحداثة المدن، وبهاء المدن.. وعشوائيات المدن.. مدننا.. لكن للحديث بقية، والحقائق ليست دوما سهلة بسهولة الحكي السهل..
في إحصائية اترك تقديرها لوعيكم.. أعلن الخبراء أنه بحلول العام 2020 سيعيش نصف سكان القاهرة مثلاً ضمن الأحياء المخالفة.. ضمن العشوائيات!!
بكل الأحوال نعود لمدننا المقدسة.. نعود للشام، للقاهرة، للجزائر، للرباط، لمراكش، لعمان لكل مدننا المسورة بأحزمنة من فوضى، نعود لعشوائياتها ونسأل سؤالا آخر..
لم تخيفنا الأبنية المرتجلة، لمَ ننتفض من بشاعتها، واعتباطيتها.. وتداخلها المتاهاتي، الشيطاني، واندغام وظائف زواريبها ما بين فسحات للتنفس والشرب، والغسيل والاستحمام والتبول..!! ما الذي تستطيع تلك الأشكال الموحدة، البلهاء، المتقشفة للأبنية تعريفه، تكريسه، تقريره، صنعه..؟؟ هل تشبه البيوت أصحابها.. لمَ يزعجنا الفقر.. وهل هو عيب..!! هل هو مخيف.. هل هو مهدد للسلم؟؟ للأخلاق؟؟ يفتقر للحدود الدنيا للإنسانية وشروطها..
على كل سنحكي حكاية.. حكاية تخصني..
كنت من زائرات حي الكبّاس الأشد إخلاصا!! في كشكول تحديدا.. منطقة عشوائية بامتياز على الرغم من تموضعها في قلب مدينة دمشق ، تقترب من حي عريق هو باب توما مثلا، من العباسيين، من جرمانا.. نعود للكباس.. لكشكول.. إذ لطالما هدرت غير نادمة، ساعات طوال أمضيتها ضاحكة، من حكايا لا تحصل إلا هناك.. بوجوه من السنغال، والدير، والساحل، وحمص.. كنا نمر وأصدقائي بخليط ألوان ولهجات، وروائح، ودكاكين يطل أصحابها من شبابيك الغرف نفسها.. دكاكين هائلة العدد، تبيع الكحول الرخيص، والدخان الوطني والمهرب، والفاكهة الأكثر رواجاً، تبيع الجبس، وفي أحسن الأحوال البطيخ الأصفر!! نمر شلة كبيرة بالناس، نسلم على الجميع.. حيث يجلس الجميع على المصطبة المرتفعة سنتمترات عن أرض الشارع الموحل، من المياه التي رشت أمام البيوت، وتركت برك وحل، يجلس الكل عليها وحولها، أباء وأبناء وأجداد.. صياح يملأ الفضاء، يقتسمون المساحة أمام الدور، يهربون من الحر ، من شوي الاسمنت لجلدوهم طوال النهار.. طوال سطوع الشمس، ينتظرون المغيب ويشربون المتة..
في منزل صديق، يمارس الأحلام مخلوطة بالصحافة.. أمضيت بصحبته أوقاتاً ممتدة.. استمتعت بكل ثانية مع الأصحاب المنفيين من منازلهم، من أبائهم، وقراهم، وأهلهم.. كنا نسهر طويلا على السطح المشترك الذي تقطنه خمس عائلات، بخمس غرف متراصة، وشباك لكل منها.. حمامهم مشترك، مطبخهم مشترك، مشاكلهم، صياحهم، وثوانيهم الأكثر حميمية.. بالطبع مشترك.. صديقي المدلل كان يسكن غرفته وحيدا، إلا عندما قررت الوالدة الرؤوم، زيارته فجأة لمراجعة طبيب، ويحكي صاحبنا حانقاً، باكيا، ضاحكا، كيف شاركه كل أهل الحارة معارفه الهامة.. الغير مطلوبة،الغير مطالب بها، تشاركوا بألوان ملابس أمه الداخلية التي لم يحلم حتى والده بمعرفتها، خاصة عندما طار سروالها وحط على السطح الملاصق لمنزله، فوق دش الجيران.. ويحكي الصديق عن عرض أمه المهان، ولون سروالها الداخلي الأبيض العريض المورد بالأحمر القاني!!
ويصيح شبه باكٍ: لك فضحتينا يا إمي.. طيب على القليلة سكري الشباك وقت بتلبسي، ما بيكفي طار الكلسون.. وتبكي الأم التي اعتادت على المساحة، و بيوت بلا أبواب.. وعيون تغض الطرف..
"شو بعرفني يا إمي والله ما انتبهت!! الله يقطعلك هالبيت ما أوحشه !!"
على السطح المشترك، الفضاء الوحيد المتاح، كنا نجلس متلاصقين، يدخن أصدقائي النرجيلة، وأشرب ما أشاء، بالقرب من الحبق الذي زرعته والدة صديقي في طشت غسيل قبل أن تغادر!!
كان الضحك ينبثق من كل معاناة يعيشها صديقنا، ونشمت بها نحن!!
بفلوكلورية تعاملنا مع معاناته، وبالواو.. من المكان الإكزوتيك، المتحرر، والجارات اللعوب، اللواتي لا يتوانين عن فعل ما لا يفعل عادة!! نحتفل ببساطة الأخلاق، بانفلات الأخلاق، وانتقامنا من تربية الأهل، والبرجوازيات العفنة، والقيم، والمعايير، والبريستيجات، والصح والخطأ، والذي يجوز ولا يجوز!!
نضحك من شلة زعران طالما تربصوا لصاحبنا بالشبريات، هزوؤا من كتبه، وشنطة اللاب توب التي يحملها فارغة!! وكيف ضربوه مرة أمام صديقة اصطحبها وحيدة إلى غرفته عندما كان لديه موعد "تن تنى.. تن تنى "!!
يحكي صديقنا بحنق عن معاناته مع أخلاقيات المكان التي لم يعتدها.. يحكي عن جيرانه الذين زرعوا سطحه دشات، وخزانات ماء، ومازوت.. يعبئونها، يصلحونها مطلين على غرفته وحياته وتفاصيله، يسيرون بملابسهم، أو بدونها، وأجسادهم المعروضة أينما شاؤوا، في أي ساعة شاؤوا..
نحن نضحك، وصديقنا يحمر مثل فجلة بهية.. نتابع الضحك، وننظر تجاهه، خاصة عندما أطل جار له من الشباك، نازعا البلورة المرمية في وجه الريح على عجل، في ليلة باردة كانونية، مصححاً معلومة في النقاش المحتدم بين شلتنا، عن تقصير الحكومة في حل مشكلة الكهرباء المقطوعة، وأزمة المازوت الماضية.. وقف الجار أمام الشباك، مزيحا الستارة، محاطا بإطار الشباك المخزوق الشبك، بثقل ظل لا يغتفر، ظل يفتي مطلا برأسه الأشعث مثل القرد، من الشبك المعدني، الذي لم يتسع لصلعته عندما سحبها متراجعا عندما أنهى فتواه الكارثية شاتماً الظروف الدولية والحصار الأميركي..
نحن نقهقه وصديقنا العتيد يغلي من انتهاك الخصوصية.. وينظر تجاهنا كي نفهم، ولا نفهم، ونتابع..
حسنا لا زلنا في الضحك.. خاصة عندما ستصل نورما إلى الكبّاس، قد تزورها خالتي أم سمعان، أو لا تفعل.. قد تضيّع سروالها، أو لا تضيعه.. قد تضحك، أو لا تضحك.. لكننا نبقى في السؤال الأول.. ما الذي يخيفنا من كل ما قلنا وحكينا، وشرحنا.. ما الذي يخيفنا من الفوضى، وسوء الخدمات، والانفلات، والفقر؟؟
حسنا لا إجابة لدي.. سؤالي أضعه بين يديكم..
أنا ضحكت.. ولأننا ضحكنا، لا يبقى لي سوى السؤال.. خاصة أننا نسينا في حمأة القهقهة أن نتكلم عن ثقافة مكان تبيح بلامبالاتها لواط الأطفال، وتُمارس فيها كل أنواع الرذائل، وتسهّل فيها كل أشكال الدعارة، ويُنتج فيها العنف والجريمة مضاعفين، والتطرف الفكري والديني والاجتماعي أضعافا مضاعفة، نسينا التحدث عن الضيق، والأماكن الخانقة المكتظة، نسينا الحديث عن شراسة أنواع من الكلاب، مزقت بعضها عندما جُمعت في مساحة ضيقة، وازدادت شراسة مع ازدياد عددها، وضيق فضاءها المتاح..
ضحكنا ونسينا أن للعيش البشري شروطاً أخرى.. نسينا حديث الريف والمدينة فقد ضاعا الاثنان.. فُقدا الاثنان .. فُقد الجمال.. ضاعت الصفة، عجنت الأشكال والهندسة والعمارة بالقذارة والمجارير المفتوحة والكهرباء المقطوعة، وندرة مياه الشرب.. ضاعت المدن، وصفات المدن في خلطة بشعة مكونها الرئيسي والوحيد هو الفقر.. ونسأل مرة أخرى وأخيرة هل هو عيب.. هل الفقر عيب!!؟؟
للإجابة ندعو المهتمين للسكن ولو مؤقتاً على أطراف مدينتا الجميلة المسورة بالعشوائيات.. ندعوكم للسكن في حي الستة والثمانين العتيد.. وللحديث تتمة..
عبير اسبر